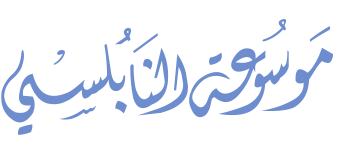الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس السابع والثلاثين من دروسِ مدارج السالكين، في منازِلِ إيّاكَ نعبدُ وإيّاكّ نستعين.
منزِلةُ اليوم متعلقةٌ بآخرِ منزلةٍ تحدثنا عنها في دروسٍ سابقة، إنها منزِلةُ التوبة، وهيَ آخر منازل التوبة، إنها منزِلةُ استئناف التوبة، قد يسألُ سائل: ما معنى استئناف التوبة؟ ليسَ من الصواب أن تتوهم أن التوبةَ تتِمُّ في العُمرِ مرةً واحدة، إنكَ تُبتَ حينما تعرّفتَ إلى اللهِ عزّ وجل، ولكنَّ التوبة ينبغي أن تكونَ منزِلةً مستمرةً مع المؤمن، بل إنَّ نهايتهُ تُختمُ بالتوبة.
إليكم التفاصيل، الإنسان حينما يكونُ غارِقاً في المعاصي، قبلَ أن يصطلِحَ معَ الله، قبلَ أن يعقِدَ العزمَ على طاعته، قبلَ أن يحمِلَ نفسهُ على الاستقامةِ على أمرِ الله، قبلَ هذا كانَ تائهاً، وشارِداً، وضالاً، وعاصياً، أدركَ خطورةَ ما هوَ فيه، أدركَ عَظَمةَ اللهِ عزّ وجل، انعقدَت في نفسهِ عزيمةٌ على التوبة، وعلى أن يُقلعَ عن كُلِّ ذنبٍ من فورِهِ، وأن يعزِمَ على ألا يعودَ إليه، وأن يندمَ على ما فعلهُ في الماضي، هذه التوبة نقلتهُ من المعصيةِ إلى الطاعة، من الشرودِ إلى الهُدى، من الضياعِ إلى الوجدان، لكن بعدَ أن تابَ وفتحَ معَ اللهِ صفحةً جديدة، بعدَ أن عاهدَ الله عزّ وجل على أن يلتزمَ أمرهُ، وأن ينتهي عما عنهُ نهى، الآن يدخلُ في منزِلةِ التوبةِ المُستمرّة تحقيقاً للقول: المؤمن مذنب توّاب، والمؤمن واهن راكع،
(( وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ))
[ أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. ]
لأن المؤمن حينما يتوب توبةً نصوحاً قد يُفاجأ بسلوكٍ كانَ يَظُنهُ صواباً، فإذا هوَ خطأٌ بعدَ معرفةِ، أو اطّلاعٍ، أو سماعِ محاضرةٍ، أو قراءةِ كتابٍ، يجدُ أنَّ هذا الموقف ليسَ صحيحاً، إذاً كلما اكتشفتَ خطأً في سلوكك، أو تقصيراً في أداءِ واجِبِك، أو انحرافاً عن جادّة الصواب، في الوقت التالي لابُدَّ من أن تعقِدَ توبةً تغطي بِها هذا التقصير أو ذاكَ الانحراف، إذاً أنتَ في توبةٍ مستمرّة.
التوبة الأولى نقلتكَ نقلةً نوعيةً من المعصية إلى الطاعة، من الشقاء إلى السعادة، من الضياع إلى الهُدى، من الشرود إلى الوجدان، لكن التوبةَ المُستمرّة التي ينبغي أن تُرافق المؤمن، كُلما اكتشفَ أنَّ هذا الموقف لا يُرضي الله، أو أنَّ هذه الفِكرة ليست صحيحةً عن اللهِ عزّ وجل، أو أنَّ هذا الظن لا يليقُ باللهِ جلَّ وعَلا، أو أنَّ هذا الاعتقاد اعتقادٌ فاسد بنصِ الآية الكريمة، أو أنَّ هذا العمل مما يُخالف السُّنّة، لأن هناك نقطة دقيقة جداً، هوَ أنكَ إذا عَرَفتَ اللهَ عزّ وجل بقي عليكَ أن تَعرِفَ مَنهَجَهُ، هل يُمكن أن تَعرِفَ مَنَهجَهُ في ساعةٍ واحدة؟ في يومٍ واحد؟ في شهرٍ واحد؟ في سنةٍ واحدة؟ معرفةُ منهجُ اللهِ عزّ وجل تتنامى، فكُلما كشفتَ موقِفاً للنبي عليهِ الصلاة والسلام لم يكن يخطُر على بالِك، لابُدَّ من أن تتوبَ عن جهلِكَ لهذا الموقف، وعن السلوك الذي يُخالفُ هذا الموقف، إذاً أنتَ في توبةٍ مستمرّة، هذا معنى: المؤمن مذنبٌ توّاب، معنى مُذنب، أي كانَ يَظُنُّ أنهُ إذا تحدّثَ عن العُصاة مُقرّعاً، موبّخاً، محتقراً يُرضي اللهَ عزّ وجل، فإذا بهِ يرى أن في السيرةِ النبويةِ موقِفاً آخر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءهُ عِكرمة مُسلِماً قالَ لأصحابِهِ: جاءكم عِكرِمةُ مُسلِماً، فإيّاكم أن تَذُمّوا أباه، أبوهُ أبو جهل أعدى أعداءِ الإسلام، أعدى أعداءِ النبي، نكّلَ بأصحابِهِ وقتلهم، قال: إيّاكم أن تَذُمّوا أباه فإنَّ ذم الميت يؤذي الحي ولا يبلُغ الميت، هوَ كانَ حينما يتحدّثُ عن الكُفار يَظُنُّ أنَّ اللهَ يُرضيهِ ذلك، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقفُ هذا الموقفَ الكامل، إذاً هوَ حينما كانَ يفعلُ هذا كانَ يُرضي اللهَ بهذا، لكنهُ اكتشفَ أنَّ هذا الموقف هُناكَ موقِفٌ أكملُ مِنهُ، كانَ يفعلُ كذا، ثمَّ رأى أنَّ الشرعَ ينهى عن كذا.
أنت ليسَ في إمكانِكَ في أسبوعٍ أو شهرٍ أو سنةٍ أن تستوعِبَ مَنهجَ اللهِ كُلهُ، قد تستوعـب الخطوط العريضة فيه، قد تستوعب الكُليّات، لكنَّ الجزئيات، أنتَ كُنتَ تختلي مثلاً معَ زوجةِ أبيك في غيبةِ أبيك، بعدَ عشر سنوات قرأتَ في كُتب الفِقهِ أنهُ لا يجوزُ الخلوةُ لا بزوجةِ الابنِ في غيبةِ الابنِ، ولا بزوجة الأب في غيبة الأب، هكذا نصّ العُلماءُ والفُقهاء، إذاً أنتَ تتوبُ من هذا الجهل الذي كُنتَ واقعاً فيه، كُنتَ تتحدثُ أحياناً عن علاقةٍ زوجيةٍ أمامَ والِدِ زوجتِك، ثمَّ كشفتَ أنَّ من آدابِ النبي عليه الصلاة والسلام أنهُ لا يتحدثُ عن أيّةِ علاقةٍ نسائيةٍ أمامَ أبِ الزوجةِ أو أخِ الزوجة، لِئلا يذهبَ بهِ الخيالُ إلى شيء ينزعجُ منهُ، كُلما فعلتَ شيئاً وأنتَ تظنهُ هوَ الصواب رُبما كشفتَ في السيرةِ النبوية أو في الحديث النبوي الشريف ما يُخالِف هذا، إذاً أنتَ تتنامى معرِفَتُكَ لمنهجِ اللهِ عزّ وجل، فكُلما بَلَغَكَ شيء عن رسول الله كُلما وصلَ إلى عِلمِكَ شيء لم تكن تعلمهُ من قبل، أو كُنتَ تفعلُ خِلافهُ، لابُدَّ من أن تُحدِثَ توبةَ، لكن إحداث هذه التوبة سهلٌ جداً، قال تعالى:
﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54)﴾
هذا السوء بجهالة، فالإنسان كُلما فعلَ شيئاً لم يكن يعلم أنهُ مُخالفة أو أنهُ معصية يجبُ أن يعقِدَ توبةً مع اللهِ عزّ وجل.
إذاً ليسَ هُناكَ توبةٌ وحيدةٌ يتيمةٌ فريدةٌ تتوبُها وانتهى الأمر، هذه التوبةُ الكُبرى التي نقلتكَ من المعصيةِ إلى الطاعة، من الضياعِ إلى الهُدى، من الشقاءِ إلى السعادة، من القلقِ إلى الطُّمأنينة، من التيهِ إلى الوجدان، هذه التوبةُ الأولى هيَ أجملُ توبةٍ تتوبُها في حياتِك؛ هيَ التوبةُ المُسعِدة، هيَ التوبةُ التي أخرجتكَ من الظُّلماتِ إلى النور، من شقاءِ الدُّنيا إلى نعيمِها، لكنكَ بعدَ أن سلكتَ في طريق الإيمان أنتَ بحاجةٍ إلى توبةٍ يوميّة، كُلما اكتشفتَ شيئاً لم تكن تعرِفهُ من قبلُ لابُدَّ من أن تعقِدَ توبةً خاصةً بهِ، كُلما كشفتَ تقصيراً أو مُخالفةً لم تكن تعهَدُها مُخالفة يجبُ أن تعقِدَ العزمَ على تركِها، هذا المعنى الذي يُستنبط من استمرارِ التوبة.
من معاني الاستغفار والتوبة بحقِّ النبي عليه الصلاة والسلام:
لكنك إذا قرأتَ حديثَ النبي عليه الصلاة والسلام من أنهُ يستغفرُ اللهَ ويتوبُ إليه في اليومِ أكثرَ من سبعينَ مرة، فهذا لهُ تفسيرٌ آخر، يُمكن أن يُفسّرَ هذا بأن استغفارَ النبي استغفارٌ وِقائي، هُناكَ استغفارٌ بعدَ أن تقعَ في الذنب، وهُناكَ استغفارٌ وِقائيٌ لِئلا تقعَ في الذنب، حينما تمشي في الطريق، وتشعُر أنَّ عقبةً كؤوداً كانت في الطريق، أمسكتَ مِصباحاً وأضأتهُ، حينما تمشي في طريق، وتتعثرُ في هذا الطريق، ومعكَ مِصباح، تُضيء المِصباح لِترى هذه العَقَبَة التي ألقتكَ جانباً، لكنكَ إذا أضأتَ المِصباحَ قبلَ أن تسلُكَ هذا الطريق لا تقع أو لا تتعثر، فأنتَ إمّا أن تكشِفَ العَقَبَةَ بعدَ أن تقعَ بِها، وإمّا أن تكشِفها قبلَ أن تقعَ بِها، فبعضُ العُلماء قال: استغفارُ النبي صلى اللهُ عليهِ وسلم استغفارٌ وِقائي، كانَ يستغفِرُ اللهَ، وكانَ يُقبِلُ عليه، وكانَ يُكثِرُ من الدُعاء، لِئلا يقعَ في الذنب، فهذا معنى،
(( عن أَبي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. ))
2-الشعور بالتقصير تجاه معرفة الله عز وجل:
هناك معنى آخر، هوَ أنكَ إذا تعرّفتَ إلى إنسان، وقال لكَ: أنا تاجر، فظننتَ أنَّ حجمَهُ المالي كذا، ثمَّ اكتشفتَ أنَّ حجمهُ المالي أضعاف أضعافَ ما توهمت، ألا تشعر بأنكَ لم تُعطِهِ حقهُ؟ لم تُقدّرهُ حقَّ قدرِهِ؟ فحينما تتعرفُ إلى اللهِ عزّ وجل-وللهِ المثلُ الأعلى-وتكتشف أنَّ معرِفَتُكَ باللهِ عزّ وجل لم تكن في المستوى الذي ينبغي ألا تشعر بالتقصير؟ أي حينما تظنُّ أن فُلاناً لن يُكرِمكَ، ثمَ هوَ يُكرِمُكَ، ألا تستحي فيما بينَكَ وبينَ نفسِكَ من هذا الظن السيئ؟ فهذا معنى آخر من معاني الاستغفار والتوبة لحقِّ النبي عليه الصلاة والسلام.
والآن الذي يقول: أنا تُبتُ إلى الله حينما استقمتُ على أمرهِ، وانتهى الأمر، ولستُ الآن بحاجة إلى التوبة، فالجواب على هذا السؤال هو أنك هل أديتَ حق اللهِ عز وّجل؟ هل عَمَلُكَ الصالح يُغطي فضلَ اللهِ عليك؟ هل طاعَتُكَ للهِ عزّ وجل في مستوى الفضلِ العظيم الذي تَفَضّلهُ اللهُ عليك؟ أغلبُ الظن لن تقولَ نعم، لأنهُ ما من أحدٍ استطاعَ أن يوفّي اللهَ حقَهُ حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرِفُ اللهَ إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام أشدُّنا معرِفةً بالله، لكنهُ لم يعرِفهُ حقَّ المعرِفة، إذاً يُمكن أن تستغفِرَ اللهَ وأن تتوبَ إليه من معرِفتكَ المحدودة التي لم تكن في المستوى المطلوب، هذا معنى آخر، أنا كُل هذا الكلام من أجلِ ألا تأخُذكّ العِزةُّ بإيمانِك وباستقامتِك، أنا استقمت وانتهى الأمر، هذه عِزّةٌ لا تُرضي اللهَ عزّ وجل، يجبُ أن تشعُرَ بالتقصير المُستمر، لأنكَ إذا شعرتَ بالتقصير المستمر كُنتَ قريباً من اللهِ عزّ وجل، لأنَّ الانكسارَ أقربُ الأبواب إليه، بابُ الانكسار بابٌ واسعٌ، لكنَ الناسَ قلّما يسلكونَهُ، هُناك أبواب إلى الله كثيرة، لكن أسرع هذه الأبواب بابُ الانكسار، فلذلك الإنسان حينما يأتي رَبهُ مُتذللاً، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لمّا سألهُ جبريل: أتُحِبُّ يا مُحمدُ أن تكونَ نبيّاً مَلِكاً أم نبيّاً عبداً؟ قالَ: بل نبيّاً عبداً؛ أجوعُ يوماً فأذكُرهُ وأشبعُ يوماً فأشكُرهُ، لأنَّ الانكسار والضعف أقربُ إلى العبودية إلى اللهِ عزّ وجل، إذاً أنت ينبغي، انظر الآية:
﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)﴾
لم يقُل اللهَ عزّ وجل: كلا إنَّ الإنسانَ ليطغى أن استغنى، قال: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ هوَ توّهمَ أنهُ مستغنٍ عن اللهِ عزّ وجل، الإنسان متى يطغى؟ متى ينقطع؟ متى يبتعد؟ إذا ظنّ أنهُ مستغنيّاً عن اللهِ عزّ وجل، فإذا الإنسان لم يجد لهُ معصيةً ولا مخالفةً، وأحكمَ استقامتهُ، وتوهّمَ أنَّ هذه الاستقامة كافية كي تُنجّيهِ من عذاب الدُّنيا والآخرة، وقعَ في حالة الاستغناء، وهذه الحالةُ لا تُرضي اللهَ عزّ وجل، لذلك قالَ ابنُ عطاء الله السَّكندريّ: رُبَّ معصيةٍ أورثت ذُلاً وانكساراً خيرٌ من طاعة أورثت عِزّاً واستكباراً، ما دُمتَ لم تُوفِّ اللهَ حَقّهُ، ولم تكُن أعمالُكَ في مستوى فضلِهِ عليك، ولا في مستوى إكرامِهِ لك، منحكَ نِعمة الوجود، ومنحكَ نِعمة الإمداد، ومنحكَ نعمة الهدايةِ والرشاد، قال تعالى:
﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)﴾
إذاً لابُدَّ أن تشعُرَ بالتقصير المُستمر، ولابُدَّ أن تشعر بالحاجةِ المُلحّةِ إلى توبةٍ من كُلِّ هذا التقصير.
منزلة التوبة والآيات الواردة في القرآن الكريم:
مما يؤكّدُ أنَّ منزِلةَ التوبةِ هيَ البدايةُ، وهيَ المنزِلةُ التي تُرافِقُ المؤمن طَوالَ حياتِهِ وهيَ النهاية، هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم.
النبيُ عليه الصلاة والسلام غزا غزواتٍ كثيرة، آخِرُ هذه الغَزوات هي أشدُّها، غـزوةُ تبوك، حينما قَفَلَ النبي من غزوةِ تبوك قالَ اللهَ عزّ وجل:
﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117)﴾
نهايةُ المطاف، نهايةُ الغزوات، نهايةُ الجِهاد، توبةُ من اللهِ عزّ وجل، معنى التوبة هُنا أي كأنَّ اللهَ قَبِلَ هذا العمل، قَبِلَهُ وتغاضى عن الأخطاء، وتغاضى عن الشوارد، وتغاضى عن الشُّبُهات التي رافقت هذا العمل، أي قَبِلهُ مِنك، فالتوبةُ هُنا نهايةُ العمل.
شيءٌ آخر وردَ في القرآن الكريم هي سورةُ النّصر أو سورة الفتح، إذ قالَ اللهُ عزّ وجل:
﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)﴾
أيها الإخوة الأكارم؛ في الصحيحِ أي في الحديثِ الصحيحِ أنهُ صلى اللهُ عليهِ وسلم ما صلّى صلاةً بعدَ أن نَزَلت هذه السورة إلا قالَ فيها:
(( عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا، قَالَتْ: ما صَلَّى النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم صَلَاةً بَعْدَ أنْ نَزَلَتْ عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَفَتْحُ} إلَّا يقولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. ))
ألم يقُل اللهُ عزّ وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ*وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً*فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ ، ((قالت: ما صَلَّى النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم صَلَاةً بَعْدَ أنْ نَزَلَتْ عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَفَتْحُ} إلَّا يقولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) بعضُ أصحابِ النبي بإدراكٍ دقيق، واستنباطٍ حكيم، وفِطنةٍ كبيرة، شعرَ أنَّ هذه السورة فيها نعوة النبي صلى اللهُ عليهِ وسلم، لأنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام حينما نَزَلت هذه السورة كانَ يقول: اللهمَّ اغفر لي، وألحِقني بالرفيق الأعلى.
بطولة الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل:
إخواننا الحاضرون؛ لابُدَّ من هذا اللِقاء مع الله عزّ وجل، البطولة أن تستعِدَّ لهُ، أن تُصفّي كُلَّ المُشكلات، أن تُصفّي كُلَّ العلاقات، أن تهيئ عملاً تلقى اللهَ بهِ، أن تهيئ عملاً يُرضي اللهَ عزّ وجل، فلذلك ربُنا عزّ وجل يُحِبُكَ أن تستعِدَّ للقائه.
وكُنتُ أقول لكم دائماً: إنَّ الأعراضَ المَرَضِيّة التي تُصيبُ الإنسانَ بعدَ سِنِّ الأربعين هيَ في حقيقتها، وفي جوهرِها، وفي دلالِتها إشارةٌ لطيفةٌ لطيفةٌ لطيفة لهذا المؤمن أن يا عبدي قد اقتربَ اللقاء فهل أنتَ مُستعد؟ أي الإنسان يضع نظارات بعد سِنّ مُعيّنة، يقول لكَ: صار هناك تصلّب بالقرنيّة أو بالجسم البلوري، فمُعظم الناس بعد سِنّ معينة يضع نظارات، يشيبُ شعرهُ، ينحني ظهرهُ، تضعفُ ذاكرتهُ، جميعُ الناس هكذا.
إذاً النبي عليه الصلاة والسلام حينما نَزَلت هذه السورة كانَ يقول: اللهمَ اغفر لـي، وألحِقني بالرفيق الأعلى.
ضرورة الاستغفار بعدَ الصلاة:
هناك شيء علّمنا إياه من النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار بعدَ الصلاة، وبعدَ الصوم، وبعدَ الحج، وبعدَ كُلِّ عِبادة، أي يا ربي أنا صِمت رمضان، لكن لعلّي لغوتُ في رمضان، لعلّي قصّرت، لعلّي شردت، لعلّي صليتُ صلاةَ جوفاء، اغفر لي هذا التقصير يا رب، بل إنَّ الإنسان حينما يُصلّي الصلوات الخمس، أولُ دُعاءٍ أُثِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدَ الصلاة ما هو؟ الاستغفار، أستغفِرُ اللهَ العظيم الذي لا إلهَ إلا هوَ الحيَّ القيوم وأتوبُ إليه ثلاث مرات، تستغفر من ماذا؟ أنتَ وقفتَ لتُصلي، لعلَّ في الصلاةِ خللاً، لعلَّ في الصلاةِ تقصيراً، لعلَّ في الصلاةِ شروداً، لعلَّ في الصلاةِ زيغاً، لعلَّ في الصلاة سُرعةً، لعلَّ في الصلاةِ شيئاً لا يُرضي الله عزّ وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانَ يستغفرُ اللهَ عَقِبَ الصلوات، وعَقِبَ كُلِّ عِبادةٍ كبيرة، عَقِبَ الصوم وعَقِبَ الحج كان يستغفر، ما قولكم أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعودُ من الحج ماذا كانَ يقول؟
(( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ. ))
أي تائبونَ عن تقصيرٍ وقعنا بهِ في مناسِك الحج، وكانَ عليه الصلاة والسلام يختِمُ عملَ اليوم بالاستغفار، فقبلَ أن ينام يقول: أستغفرُ اللهَ الذي لا إلهَ إلا هوَ الحيُّ القيوم وأتوب إليه، يستغفر اللهَ قبلَ أن ينام، وعلّمنا أيضاً أن نستغفِرهُ بعدَ أن نقومَ من مجلس؛ سَهِرنا سهرةً، عقدنا ندوةً، دُعينا إلى وليمة، لعلّ في هذه الوليمة كلمة لا تُرضي الله، لعلَّ في هذه الوليمة نظرة أو في هذا الحديث خللاً أو هنهاً، فأنتَ حينما ينتهي مجلِسُكَ استغفر الله، حينما تنتهي صلاتُكَ استغفر الله، حينما ينتهي صيامُك استغفر الله، قال تعالى:
﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)﴾
شرف الإنسان في عبوديتهِ للهِ عزّ وجل:
بل إنَّ العبدَ أحوجُ ما يكونُ إلى التوبةِ في نهايةِ عُمره، لذلك منزَلةُ اليوم منزَلةُ استئناف التوبة، أنتَ تبدأُ التوبة وتستمرُ بِها، وتُنهي بِها هذا العُمر الذي أمضيتهُ في معرفة الله وطاعته، الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهِ الله، وعلى عُمُره الثمين، حينما أقسمَ اللهُ بِعُمُرِهِ حيثُ يقول:
﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)﴾
واللهُ سبحانهُ وتعالى في عِدّةِ آيات ذكرَ النبي عليه الصلاة والسلام، وهوَ في أعلى مرتبة، وأعلى مرتبة أن يكونَ عبداً للهِ عزّ وجل، قال تعالى:
﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)﴾
و:
﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19)﴾
قال تعالى:
﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1)﴾
كُلُّ هذه الآيات تُبيّنُ أن شرفَ الإنسان في عبوديتهِ للهِ عزّ وجل.
الآية الدقيقة:
﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66)﴾
أي أنتَ أيها العبد لكَ مُهِمةٌ واحدة أن تتعرفَ إلى أمرِ اللهِ ونهيه، وأن تلتزِمَ أمــرهُ، وأن تنتهي عما عنهُ نهى، وهُنا تنتهي مُهمَتُكَ كعبد، فلهذا تُعدُّ بعضُ العِبادات إعلاناً عن عبوديتُكَ للهِ عزّ وجل.
الحج؛ نحنُ في موسم الحج الآن، لماذا تَحُجُّ البيت؟ إنكَ من بعض معاني الحج تُعلنُ عن عبوديتِكَ للهِ في الحج، تأتمر بأمرهِ، تدعُ بيتَكَ، وأهلكَ، وأولادكَ، وعملكَ، ومركزكَ، وتخلعُ ثيابَكَ، وتخلعُ مع ثيابِكَ الدُّنيا كُلها، ومرتَبَتكَ الاجتماعية، وتُلّبي ربكَ، وتقول: لبيكَ اللهم لبيك، هُنا تقصُّ شعركَ، وهُنا تمتنع عن أن تَحُكَ جِسمك، أو أن تغتسل، أو أن تتطيب، تُنفّذُ محظورات الإحرام تماماً، هذا كُلهُ عبودية لله عزَ وجل، وسيدنا إبراهيمُ أبـو الأنبياءِ عليه الصلاة والسلام أيضاً ذكرَ اللهُ عن مقامِهِ العظيم حينما قال:
﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)﴾
أي وفّى حقّ العبوديّة، فنحنُ مُقصّرون، إذا كان سيدنا إبراهيم وفّى، وهو أبو الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام وُصِفَ في أعلى مقاماتهِ بمرتبة العبودية والذُّل للهِ عزّ وجل، فنحنُ قد نعتدُّ بعملٍ صالح، قد نتيهُ بهِ، قد نستعلي بهِ على الآخرين، هذا كُلهُ يحتاج إلى توبة، فلذلك أن تبذُلَ الجهدَ الكبير في سبيل التقرّبِ إلى اللهِ العليّ القدير هوَ أعظمُ عملٍ وأنجحُ مسعى تسعاه إلى اللهِ عزّ وجل.
حالان ينبغي ألا يُفارِقا المؤمن:
الحال الأول: حال جمع الهمة على الله عز وجل:
الآن هناك حالان ينبغي ألا يفارقا المؤمن؛ الحال الأول حالُ جمعِ الهِمةِ على اللهِ عزّ وجل، أي بالتعبير المقبول عِندكم الالتفات إلى الله؛ أن تلتفِتَ إليه، أن تعقِدَ معهُ الصِّلة، أن تدعوَهُ، أن تستغفِرهُ، أن تُسبِّحهُ، أن تذكُرهُ، أن تلجأ إليه، أن تستعيذَ به، أن تُقبِلَ عليه، أن تعقِدَ بهِ الصِّلة، هذا الحال سمّاهُ العُلماء جمعُ الهِمةِ على اللهِ عزّ وجل محبةً وإنابةً وتوكُلاً وخوفاً ورجاءً ومراقبة، يجبُ أن تُراقِبَ الله، يجبُ أن تشعُرَ أنَّ اللهُ يُراقِبُك، يجبُ أن ترجوهُ وأنتَ في الشِّدّة، لا أن تيأسَ من عطائهِ، يجبُ أن تخافه وأنت في الرخاء، العادة أنَّ الناس يطمئنون وهم في الرَّخاء، ويخافون وهم في الشِّدّة، لكن المؤمن ينبغي أن يخافَ وهوَ في الرخاء، وينبغي أن يطمئن وهوَ في الشِّدّة، لأنها إذا وقعت الشِّدّة فلا مُنجّي إلا الله، لهذا قيل: لا يخافنّ العبدُ إلا ذنبَه ولا يرجونَّ إلا رَبه، إذا وقعتَ في شِدّة لا ينبغي أن تيأس، اليأسُ نوعٌ من الكُفر، اليأس والقنوت والسوداوية، وأنا انتهيت، وأنا هكذا الله قدّرَ عليّ، هذا كُلهُ من علامةِ ضعفِ الثِّقةِ بالله عزّ وجل، فمن شأنِ المؤمن أن يرجو الله وهوَ في الشِّدّة، ومن شأنِ المؤمن أن يخافَهُ وهوَ في الرَّخاء، الناس عادة: ﴿كَلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ إذا كان بصحةٍ طيبة، أجرى تخطيطاً، النتيجة جيدة، الضربات نظامية، التخطيط، الكوليسترول، المواد الدسمة، يقول لكَ: التحليل ممتاز، ينسى الله عزّ وجل، يذكُرهُ إذا كانت النِّسب عالية، إذا كان هناك ارتفاع بالــ UREA شديد جداً، إذا كان هناك اضطراب بالنظم، يا رب، البطولة أن تذكُرهُ وأنتَ في صحةٍ جيدة، وأنتَ في بحبوحة، وأنتَ قوي، وأنتَ غني، إذاً جمعُ الهِمّةِ على الله تكونُ في الحُب، وفي الإنابة، وفي التوكل، وفي الخوف، وفي الرجاء، وفي المراقبة، هل هُناكَ هِمَةٌ أخرى؟ هذه الهِمّةُ الأولى، جمعُ الهِمّةِ على الله شوقاً ومحبةً وإنابةً وتوكُّلاً وخوفاً ورجاءً ومراقبةً، هذه:
﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)﴾
الحال الثاني: حال جمع الهمة على تنفيذ أمر الله:
بقيَ ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: وجمعُ الهِمّةِ على تنفيذِ أمرِ الله، الآن دخلت بالعلم، دخلت في معرفة أمر الله، ما حُكمُ اللهِ في الدَّين؟ لابُدّ من كتابةِ إيصال، قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)﴾
ما حُكمُ اللهِ في الوديعة؟ ما حُكمُ اللهِ في العارية؟ ما حُكمُ اللهِ في الإيجار؟ ما حُكمُ اللهِ في المُزارَعة؟ ما حُكمُ اللهِ في المضاربة؟ ما حُكمُ اللهِ في شِراءِ الفواكه على أغصانِها؟ كمُزارع، كتاجر، كمدرس، كطبيب مثلاً، ما حُكمُ أجرِ الطبيب إذا ماتَ المريض مثلاً؟ ما حُكمُ أجرِ المُدرّس؟ ما حُكمُ أجرِ المحامي؟ يوجد عِندكَ قضية ثانية، بعدَ أن تتعرفَ إلى الله، وبعدَ أن تجمعَ هِمّتِكَ عليه محبةً وتوكُلاً وخوفاً ورجاءً وإنابةً ومراقبةً، الآن دخلتَ في طَورٍ آخر، يجبُ أن تجمعَ هِمَتَكَ على تنفيذِ أمرهِ، ولن تُنفِذَ أمرهُ إلا إذا عَرَفتَ أمرهُ أولاً، من هُنا جاءت الحاجةُ إلى حضور مجالس العِلم، وإلى معرِفةِ أمرِ الله عزّ وجل التفصيلي.
فلذلك هذا الذي لا يجدُ نفسهُ راغِبةً في معرِفة أمرِ الله عزّ وجل كيفَ يستقيمُ على أمرهِ؟ فأول خطوة في الاستقامة على أمر الله أن تعرِفَ اللهَ عزّ وجل، على كُلٍّ؛ قولُهُ تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هذه الآية جمعت الهِمتين؛ هِمةُ الإقبالِ عليه وهِمةُ تنفيذِ أمرِهِ، لذلك قالَ بعض العُلماء: إنكَ حينما تركع تُعلِنُ عن خضوعِكَ للهِ عزّ وجل، وإنكَ حينما تسجُد تطلُبُ العونَ من اللهِ عزّ وجل، فكأنَّ إيّاكَ نعبدُ ركوعاً، وإيّاكَ نستعين سجوداً.
التوبةُ ينبغي أن تكونَ مستمرّةً طَوالَ الحياة:
إذاً مِحوَرُ هذا الدرس أنَّ التوبةَ التي تتوهمونَها تقعُ في العُمرِ مرةً واحدة، هذه التوبةُ الكُبرى التي نَقَلتكَ من الشقاءِ إلى السعادة، من المعصيةِ إلى الطاعة، من الضلالِ إلى الهُدى، من الضياعِ إلى الوجدان، لكن التوبةَ التي تعقِبُ كُلّ خطأٍ طفيفٍ وكُل جهلٍ وكُل تقصيرٍ، هذه التوبةُ ينبغي أن تكونَ مستمرّةً طَوالَ الحياة، وهذا معنى القول: المؤمن مذنب توّاب، واهن راكع، ((كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)) أمّا النهاية، في نهايةِ كُلِّ صلاة، ونهايةِ كُلِّ صيام، ونهايةِ كُلِّ عُمرةٍ أو حج، ونهايةِ كُلِّ مجلسٍ، وكُلِّ لقاءٍ، وكُلِّ علاقةٍ، وفي نهايةِ العُمر ترجو الله عزَ وجل أن يقبَلَكَ، أن يقبَلَكَ بهذا العمل الذي هوَ جُهدُ مُقِلٍّ كما قالَ عليه الصلاة والسلام، أن يقبَلَكَ وأن يتجاوَزَ عن أخطائِكَ وعن سيئاتِكَ وعن زلاتك، فلعل اللهَ عزَ وجل يختِمُ هذا العملَ بتوبةِ القَبول، هناك توبة العفو وهناك توبة القَبول، تتوبُ من ذنبٍ فيقبل الله توبَتَكَ؛ أي عفا عنك، لكن الآن قد يعفو عنك ولكنه لا يقبَلُكَ، أنتَ ماذا تُريد؟ أن يقبَلَكَ الله عزّ وجل، لذلك توبةُ نهاية العُمر توبةُ القَبول.
إفرادُ اللهِ في العبادة وإفرادُهُ في الاستعانة:
أيضاً حينما تقولُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بكلمة إيّاكَ يوجد تخصيص، أي إيّاكَ وحدَكَ يا رب لا نعبُدُ سِواك، وإيّاكَ وحدَكَ يا رب لا نستعينُ بغيرِك، إفرادُ اللهِ في العبادة وإفرادُهُ في الاستعانة، حينما تتجهُ إلى أن تستعينَ بغير الله عزّ وجل أو أن تستعينَ بزيدٍ أو عُبيد، لا تنس هذا القول: ما من مخلوقٍ يعتصم بي من دونِ خلقي، أعرِفُ ذلِكَ من نيّتهِ، فتكيدُهُ أهلُ السماواتِ والأرض، إلا جعلتُ لهُ من بينِ ذلِكَ مخرجاً، وما من مخلوقٍ يعتصمُ بمخلوقٍ دوني أعرفُ ذلِكَ من نيّتهِ، إلا قطّعتُ أسبابَ السماءِ بينَ يديه، وأهويتُ الأرضَ من تحتِ قدميه، إذاً: يجبُ أن تُفرِدهُ بالعِبادةِ، ويجبُ أن تُفرِدهُ بالاستعانة، و: لا يخافنَّ العبدُ إلا ذنبَه، ولا يرجونَّ إلا ربَه، قال تعالى:
﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)﴾
العِبادة غايةُ الخضوع معَ غاية الحُبّ:
آخر شيء بالدرس أنَّ العِبادة غايةُ الخضوع معَ غاية الحُب، خضوعٌ بِلا حُبّ لا يُعدُّ عِبادة، وحُبٌّ بِلا خضوع لا يُعدُّ عِبادة، نهايةُ الخضوعِ ونهايةُ الحُبِّ هوَ العِبادة:
﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)﴾
والعِبادة الحقّة هيَ أعلى مقاماتِ الإنسان، وقد رأيتم قبلَ قليل كيفَ أنَّ اللهَ عزّ وجل وصفَ النبيَ عليه الصلاة والسلام وهوَ في أعلى درجاتِهِ، وصفهُ بأنهُ عبدٌ للهِ، ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ ، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ هذه كُلُها تؤكِدُ: أنَّ العبوديةَ هيَ كُلُّ شيء، بل إنَّ كُلَّ هذه الدروس ما هيَ إلا في تفصيلِ إيّاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين.
بقيَ موضوعٌ دقيقٌ متعلّقٌ بالعِبادة، العِبادة أيها الإخوة؛ وقد ذكرتُ هذا من قبل العبادة هيَ طاعة كما قلت قبل قليل، غايةُ الطاعة الخضوع مع غاية الحُب، لكن يجب أن تعلم عِلمَ اليقين أنكَ لن تُطيع ولن تُحبّ إلا إذا عَرفت، فطريقُ العِبادةِ هيَ المعرِفة، العِلم هوَ الطريق الوحيد إلى الله عزّ وجل، وأنكَ إذا أطعتَ وأحببت سَعِدتَ باللهِ عزّ وجل، ثلاث كلمات أتمنى على اللهِ عزّ وجل أن تكونَ واضِحةً عِندكم، ثلاث كلمات في حياتِنا؛ الأولى: المعرفة، والثانية: السلوك، والثالثة: الثمَرَةَ وهيَ السعادة، فينبغي أن تسعد، ولن تسعدَ إلا إذا أطعت، ولن تُطيعَ إلا إذا عَرفت، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانَ بليغاً جداً حينما قال:
(( عن عبد الله بن مسعود: الندمُ توبةٌ، فقال له أَبِي: أنتَ سمِعتَ رَسولَ اللهِ يقولُ: (النَّدمُ تَوبةٌ؟) قال: نعَمْ. ))
[ خلاصة حكم المحدث : حسن: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري لابن حجر ]
العلماء احتاروا بهذا الحديث، يا ربي التوبة ليست ندماً فقط، التوبة عِلم، أنتَ في أيةِ لحظةٍ تتوبُ من الذنب؟ متى؟ إذا عرفتَهُ ذنباً، لابُدّ في التوبةِ من علمٍ، فإذا حصلَ العِلمُ صار الندمُ، وإذا صارَ الندمُ نَقَلَكَ إلى السلوك، ففي أدقِّ تعاريف التوبة: هيَ عِلمٌ وحالٌ وعمل.
جاءَ االنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرَ في التوبةِ المرتبة الوسطى، قال: ((الندمُ توبة)) فالعُلماء عندما فسّروا هذا الحديث، قال: هذا الندم لابُدّ لهُ من علمٍ أحدثهُ، ولابُدّ لهُ من عملٍ نَتَجَ عنهُ، هذه البلاغة بالإيجاز، ذَكرَ لكَ المرحلة الأساسية هيَ الندم، فالندم سببهُ العِلم، والندم نتيجتهُ الاستقامة، فقال النبي: ((الندمُ توبة)) ربُنا قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ العِبادة طاعة وحُبّ، يا ربي أنتَ أغفلت العِلم وأغفلت السعادة، لأن هذه الطاعة وهذا الحُب لا يُمكن أن يكون إلا بالعِلم، وهذه الطاعة وهذا الحُب إذا حصل ينتجُ عنهُ سعادة أبديّة في الدُّنيا والآخرة، فنهاية المطاف يجبُ أن تعلم أنَّ اللهَ سبحانهُ وتعالى خَلَقَكَ كي تعبُدَهُ، أي كي تُطيعَهُ وكي تُحِبهُ، ولن تطيعَهُ ولن تُعبده إلا إذا عَرفتَهُ، وإذا أطعتهُ وأحببتهُ سَعِدتَ بقُربِهِ في الدُنيا والآخرة، إذاً حياتنا كُلها ثلاث كلمات: نتعلّم ونعمل فنسعَد، تُلغي العمل لا تستفيد شيئاً، تُلغي العِلم لا تستفيدُ شيئاً، طبعاً الثالثة تحصيل حاصل، أما عندك علم وعمل، فتجد في القرآن أكثر من ثلاثمئة آية:
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)﴾
﴿ وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾
حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح:
أنا أتمنى على الإخوان الحاضرين أن يكونَ في حياتِهم شيئان كبيران: طِلَبُ العِلمِ والالتزامُ بما تعلّمت، لهذا قيل: لا بورِكَ لي في طلوعِ شمسِ يومٍ لم أزدد فيهِ من اللهِ عِلماً، ولا بورِكَ لي في طلوعِ شمسِ يومٍ لم أزدد فيهِ من اللهِ قُرباً، القرآن يؤكّد ذلك، حجمُكَ عِندَ اللهِ بحجمِ عملِك، الدليل؟
﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132)﴾
وحجمُكَ عِندَ اللهِ بحجمِ عِلمِك، والدليل:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)﴾
فأنتَ لكَ نشاطان، نشاط هوَ التعلّم ونشاط هوَ التطبيق؛ في المسجد تتعلم وفي بيتِكَ ودُكانِكَ ومكتَبِكَ وعيادَتِكَ ومعمَلِكَ تُطبّق، هُنا تتعلم والحياةُ كُلُّها مجالٌ للتطبيق، إذاً حينما تختصر الدين بكلمات موجزة، وكلمات مُحكَمة، وكلمات بليغة، الدينُ عِلــمٌ وعمل، والثالثة تحصيل حاصل وهيَ السعادة، تحصيل حاصل، أنتَ طبّق الأولى والثانية، والثالثة تأتيكَ وهيَ راغِمةَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
الملف مدقق